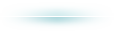الإمام الحسين (ع) في مواجهة الإلحاد
مناجاةُ عارفٍ لا غوايةَ شاعرٍ . . وليست ”غرفة سِيرَل الصينية“ أيضاً (١)
تنبيه هذه المقالة وأخواتها لم تُكتَب للكسول من الناس ولا البليد أو المتسرع أو الباحث عن النتيجة بأقرب الطرق بل تعمّد فيها الكاتب أن لا يقول ما يريد إلا في ثنايا الكلام، وليس في ذلك مخالفة للبلاغة. فإذا كنت أحد أولئك الذي مرّ ذكرهم، فهذه المقالة لا تعنيك.
(1)
عام ١٩٩٧م كانت المرّة الأولى بالنسبة لي التي تعرفت فيها في وادي عرفات على دعاء الإمام الحسين  في عرفة، الدعاء المعروف بدعاء ”عرفة“. وعلى الرغم من مرور عشرين عاماً على ذلك المشهد إلا أنّ ذكراه بل تفاصيله لا تزال في أعماق ضميري.
في عرفة، الدعاء المعروف بدعاء ”عرفة“. وعلى الرغم من مرور عشرين عاماً على ذلك المشهد إلا أنّ ذكراه بل تفاصيله لا تزال في أعماق ضميري.
ذلك العام أيضاً كان المرة الأولى لي لحجّ بيت الله الحرام؛ تلك المناسك التي تبدو للحاج أول مرّة غريبة جداً، فماذا يعني يا ترى أنّ تتجرد من ثيابك عند ميقات معيّن وتكتفي بقطعتين بيضاء، ثم تدلف إلى وادٍ أقرع تطوف فيه حول حجرٍ سبعاً، تصلي خلف مقام (موضع رجل) نبي عَمّر قبل ألفين وثمانمائة عام (كما يقول البعض ولعله أقدم من ذلك)، ثم تمشي ساعياً بين جبلين بل في موضع ما تهرول لتنتهي عند طرف أحدهما (المَرْوة) لتأخذ شيئاً من أطراف شعرك حتى تتحلل من الإحرام وتعود إنساناً سوياً؟! بل الأغرب من هذا ذلك النهر الأبيض من البشر الذين ينحدرون من مكة إلى عرفات وكأنهم طوفان مهيب مُدّوٍ يتقاطرون من كل حدب ليلاً وما يفتؤون نهاراً حتى إذا أشرق الشمس وارتفعت في كبد السماء رأيتهم قدّ ملؤوا وادي عرفات، فبات وكأنه بحيرة شديدة البياض يعلوها رأس جبل جليدي (جبل الرحمة).
لكن الأعجوبة الكبرى في يوم عرفة!
يوم عرفة ينقسم على مستوى الحدث إلى قسمين ليس لهما علاقة بتقسيمات علماء الفلك لليوم، الأول منه قبل الظهيرة، والثاني منه من بعد الظهيرة إلى غروب الشمس. في القسم الأول منه لا يزال البشر بشراً عاديين، ولا يزال اليوم بما فيه من الزمان والمكان يوماً عادياً، لكن في القسم الثاني منه تبدأ الأعجوبة؛ يتحول فيها البشر إلى إنسان، وينعدم الزمان، وتذوب الأرض، وتُظلّل السماء بالنور، وتتساقط الأمطار بلا غيوم يشعر ببرودتها كل واقف هناك، وتُزْهِر الورودُ بلا حقول، تَدْمع فيها عيون أقسى الناس، تنظر حولك فترى هذا يجأر بصوته، وذاك يعجّ بنحيبه، وذاك قد أحنى العرفان ظهره، وذاك قدّ أرخى الشوق عيْنَه، وذاك يفترش الأرض جَبْهَتَه، وذاك قدّ بَهَتَهُ جليلُ الموقف. هناك ومع اندماج الحجاج في دعاء عرفة تشهد النفس ”لحظات“ أو ”ومضات“ أو ”شعور“ يتمايز عن بقية المشاعر الإنسانية. فما طبيعة تلك ”اللحظات“؟!
(2)
القرن العشرين ليس المرة الأولى التي يحاول فيها الإنسان التعرف على مشاعره، وبالذات المشاعر الدينية، أو تلك التي توصف بمشاعر ”التقديس“ أو ”القداسة“ أو ”التعالي“. بل قد سبق هذا القرن محاولات تعود إلى بدايات الإنسان الواعي. لكن هذا القرن تميّز بأن فئة في الجزء الغربي من الأرض؛ من ذوي البشرة البيضاء والعيون الزرقاء والأهم من ذلك ممن صنع أدوات ”مادية“ واعتقد بجدواها ليس في كشف العالم الطبيعي فقط بل وفي كشف السرّ المكنون لهذا الكائن ”الإنسان“. وليس في هذا جديد بل مسيرة ”فكّ“ السحر عن العالم كانت شعاراً حمله رواد عصر ”التنوير“ واستمر مع أعقابهم جيلاً بعد جيل. إنما الجديد في ”كيفية“ هذه المحاولة.
وهنا سأبدأ بكلام دقيق نسبياً.
يقول أبو حيان التوحيدي؛ أحد مفكري العالم الإسلامي في العصر البويهي: ”إنّ الإنسانَ أشَكَل عليه الإنسانُ“. يلخص في هذه الكلمة الرائعة مشكلة معرفية ووجدانية وأخلاقية يعايشها الإنسان مع نفسه، حيث يجد في ”فطرته“ أو ”وعيه الذاتي“ أو ”محايثته“ أنه ”أكثر“ من مجرد تركيب مادي مزيج هرموني عصبي حسي. بل هو ”أكثر“. وفي هذا ”الأكثر“ تندرج عدة مظاهر؛ منها: الخيال، والإبداع، والنيّة، والإرادة، والحب، والإيثار، بل والجريمة (وهي أولى الصفات التي لاحظتها الملائكة). هذه المظاهر لا يمكن ردّها ”ببساطة“ إلى مجرد مكوّن مادي يقوم بوظائف معينة؛ مهما بلغت هذه الوظائف ذكاءً وتعقيداً. بل وتتفاوت هذه المظاهر ”الأكثر“ في أكثريتها. وسأعود إلى هذه الفكرة بعد قليل.
”غرفة سيرل الصينية“ أو ”غرفة خبيرة اللون الأحمر ماري“ أو ”الزومبيون“ أو ”طائر الخفاش المُحلّق“ كلها تجارب ذهنية تحليلة في التراث الفلسفي والعلمي الغربي تحاول مناقشة طبيعة هذه المظاهر ”الأكثر“ التي يجدها الإنسان في نفسه. وفي التراث الإسلامي تقترب هذه التجارب كثيراً من فكرة ابن سينا عن ”الرجل الطائر“.
لإثبات وجود الروح، يفترض ابن سينا إنساناً طائراً يهوي من السماء، ثم يفقد الإحساس بكل جوارحه، يتساءل ابن سينا: ترى ما الذي يبقى محسوساً أو مستشعراً به، ليستنتج من هذه تحليلياً وجود الروح.
أما طائر الخفاش المُحلّق، فقد طرحها الفيلسوف الأمريكي المعاصر توماس نيجل، حين افترض أنّ يكون الإنسان خفاشاً، وتساؤل: ترى ماذا سيفرق تحليلياً إذا صرت خفاشاً وحلقت في السماء؟ كيف ستنظر للأمور؟ هل ستتمايز نظرتك أم لا؟
أما تجربة خبيرة اللون الأحمر ماري، فتتساؤل: لو افترضنا وجود إمرأة اسمها ماري، وضعت في غرفة ليس فيها إلا لونان الأبيض والأسود منذ ولادتها، لكنها تعلمت كل ما نعرفه اليوم في علم الأعصاب والبصريات عن ”اللون الأحمر“. ثم فتحنا لها الباب لترى اللون الأحمر بعينها، وهنا بيت القصيد: ترى هل سيضاف ”شيء جديد“ لماري عند رؤيتها هذه أم لا؟ بالتالي هل هناك شيء ”أكثر“ في التجربة الشعورية للإنسان أم لا؟
وأخيراً "غرفة سيرل الصينية“، وهي التجربة الذهنية التي ابتكرها فيلسوف العقل واللغة الأمريكي المعاصر جون سيرل عندما افترض وجود جهاز أو شخص في غرفة، يُعلّم هذا الشخص أوامر لغوية صينية من خلال جملة كبيرة من القصاقات الورقية، بحيث كلما ارسلت له قصاصة من خارج الغرفة، يرد عليها بقصاصة أخرى، وهو لا يعلم أبداً محتويات القصاصات، وكل ما يعرفه أن القصاصة (أ) مثلاً يُردّ عليها بـ(ب). ومع مرور الوقت تتحول العملية عنده إلى فعل ”تلقائي“. والسؤال هنا: هل هذا الجهاز يمكن القول أنّه يعرف اللغة الصينية أم لا؟ هل اللغة وبالتالي الكلام وبالتالي التواصل أمر ”أكثر“ من مجرد ردّ على رموز أم لا؟
سيقت هذه التجارب الذهنية لتُرجّح أنّ الإنسان ”أكثر“ من مجرد تركيب حسي. وقدّ استطاعت بشكل كبير هزيمة الاتجاه الاختزالي بمختلف أطيافه في الفلسفة المعاصرة، وانتصرت بنحو ما للـ“إنسان“.
لكن القصة لا تنتهي هنا!
(3)
من جملة المظاهر ”الأكثر“ في الظاهرة الإنسانية هو ”التديّن“؛ والذي يتجسد في التعبد والإقرار والخضوع والشوق والشفق والروع والصبر . . وغيرها. فهو الآخر "قد أَشْكَلَ“ على الإنسان، وقد حاولت ثقافات كثيرة تفسيره بارجاعه إلى أو اختزاله في ”الخوف“ كشعور غريزي، أو ”الجنون“ كلاشعور مَرَضي، أو ”الشعر“ كشعور خيالي ذوقي جمالي . . لكنها في كل هذه التوصيفات مجرد ”وهم“ لا حقيقة ورائها. وهنا شابهت هذه الثقافات ومنظريها علماء العصر الحديث الماديين الذي اختزلوا الإنسان في المواد الحيوية، وهؤلاء اختزلوا التديّن في الحالات المرضية. لكن القرآن الكريم يصدع بأنّ النبوة ”وحي“ ينهمر من ”الغيب“، ويتمايز عن الشعر والجنون والخوف والكهانة والسحر والزعامات الاجتماعية.
وينقل التاريخ قصة تشابه إلى حدٍ كبير واقع الملاحدة الجدد؛ الذي ينتحلون ما يدعونه علماً (وهو مجرد علموية) لتفسير التدين، تلك قصة الوليد بن المغيرة؛ الذي يُدّعى أنّه من ”خبراء“ العرب في أحوال الأديان وسنن العرب في الكلام. وذلك عندما طلبه الملأ من قريش ليرى ما الذي يقوله النبي محمد  . فاختلس الطائفين حول البيت، ومشى خلف النبي
. فاختلس الطائفين حول البيت، ومشى خلف النبي  مستمعاً لما يقرأه من القرآن، فرقّ قلب الوليد. فلما عاد إلى أبي جهل والملأ من قريش سألوه عما سمع: أَ من شعر الجنّ هذا، أم من سجع الكهان، أَ نثر هذا أم شعر؟ فنفى الوليد أن يكون القرآن أياً مما ذكر. بل قال: ”وماذا أقول؟! فو الله ما فيكم من رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن مني، والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا، والله إن لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته“. لكن ما الحيلة في ردّ النبي
مستمعاً لما يقرأه من القرآن، فرقّ قلب الوليد. فلما عاد إلى أبي جهل والملأ من قريش سألوه عما سمع: أَ من شعر الجنّ هذا، أم من سجع الكهان، أَ نثر هذا أم شعر؟ فنفى الوليد أن يكون القرآن أياً مما ذكر. بل قال: ”وماذا أقول؟! فو الله ما فيكم من رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن مني، والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا، والله إن لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته“. لكن ما الحيلة في ردّ النبي  إذن؟ كانت الحيلة أن قال: قولوا فيه أنه سحر.
إذن؟ كانت الحيلة أن قال: قولوا فيه أنه سحر.
(4)
إلى عرفة من جديد.
الإيمان ليس مجرد عاطفة وهمية في الوجدان بل في جوهره ”إقرار“ بكامل الإرادة والعقل السليم بـ“الحقيقة“ الكبرى وهي ”الله“، ثم لا يلبث هذا الإقرار أنْ يتكامل بالمعرفة أكثر لصفات الباري عزّ وجلّ، ثم يتحول إلى عمل دائم ومستمر للتقرب من الله. وهذا ما لا يكون إلا باقتحام العقبة تلو العقبة في مسيرة للمغامرة الإنسانية إلى أن يأتيه اليقين.
الإمام الحسين  في دعاءه يوم عرفة قد عبّر عن كمال ”العرفان“ بالله وصفاته من خلال ”مناجاة“ انطلقت من الإيمان في أعلى درجاته. مناجاة تحدثت مع ”حقيقة“ واقعة وأنباء صادقة لها من الآيات ما لا تحصى، ومن الشهود ما لا ينكر، ومن الجمال ما لا يضاهي.
في دعاءه يوم عرفة قد عبّر عن كمال ”العرفان“ بالله وصفاته من خلال ”مناجاة“ انطلقت من الإيمان في أعلى درجاته. مناجاة تحدثت مع ”حقيقة“ واقعة وأنباء صادقة لها من الآيات ما لا تحصى، ومن الشهود ما لا ينكر، ومن الجمال ما لا يضاهي.
يقول  بعد أنّ سرد آيات العناية الإلهية من النعم: ”اَجَلْ وَلوْ حَرَصْتُ اَنَا وَالْعآدُّونَ مِنْ اَنامِكَ، أَنْ نُحْصِىَ مَدى اِنْعامِكَ، سالِفِهِ وَآنِفِهِ ما حَصَرْناهُ عَدَداً، وَلا اَحْصَيناهُ اَمَداً، هَيْهاتَ أنّى ذلِكَ وَاَنْتَ الُْمخْبِرُ فى كِتابِكَ النّاطِقِ، وَالنَّبَأِ الصّادِقِ، وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوها، صَدَقَ كِتابُكَ اَللّهُمَّ وَاِنْبآؤُكَ، وَبَلَّغَتْ اَنْبِيآؤُكَ وَرُسُلُكَ، ما اَنْزَلْتَ عَلَيْهِمْ مِنْ وَحْيِكَ، وَشَرَعْتَ لَهُمْ وَبِهِمْ مِنْ دينِكَ“.
بعد أنّ سرد آيات العناية الإلهية من النعم: ”اَجَلْ وَلوْ حَرَصْتُ اَنَا وَالْعآدُّونَ مِنْ اَنامِكَ، أَنْ نُحْصِىَ مَدى اِنْعامِكَ، سالِفِهِ وَآنِفِهِ ما حَصَرْناهُ عَدَداً، وَلا اَحْصَيناهُ اَمَداً، هَيْهاتَ أنّى ذلِكَ وَاَنْتَ الُْمخْبِرُ فى كِتابِكَ النّاطِقِ، وَالنَّبَأِ الصّادِقِ، وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوها، صَدَقَ كِتابُكَ اَللّهُمَّ وَاِنْبآؤُكَ، وَبَلَّغَتْ اَنْبِيآؤُكَ وَرُسُلُكَ، ما اَنْزَلْتَ عَلَيْهِمْ مِنْ وَحْيِكَ، وَشَرَعْتَ لَهُمْ وَبِهِمْ مِنْ دينِكَ“.
وبهذا يُعرف أنّ الإيمان ”يتمايز“ في النفس الإنسانية عن المظاهر الشعورية السليمة أو المعقدة، فضلاً عن أن يكون مُسبَباً عن مكونات عصبية هرمونية مادية.